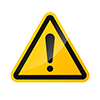سجلات المحكمة الشرعية "الحقبة العثمانية" – المنهج والمصطلح
جمع الباحث خالد زيادة في كتابه هذا أعمالًا أعدّها خلال اشتغاله على وثائق محكمة...
Also Available in:
- Amazon
- Audible
- Barnes & Noble
- AbeBooks
- Kobo
More Details
جمع الباحث خالد زيادة في كتابه هذا أعمالًا أعدّها خلال اشتغاله على وثائق محكمة طرابلس الشرعية، والتي يبتدئ تاريخها في عام 1077هـ/ 1666م. وانطلق في بحثه المستفيض من أن وثائق المحاكم الشرعية تحتل موقعًا مميزًا بين مجموعات الوثائق التي يمكن أن يستند إليها المشتغلون بالتاريخ في الحقبة العثمانية، كالوثائق القنصلية والتجارية والكنسية وغيرها، مع تميز وثائق المحاكم الشرعية باتساع موضوعاتها لتشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن حفظها ما كان يرد من عاصمة الدولة العثمانية من فرمانات ومراسلات.
خطاب السجلات
يتضمن الكتاب ثلاثة أقسام؛ ويضم القسم الأول "الصورة التقليدية للمجتمع المديني: قراءة منهجية في سجلات محكمة طرابلس الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر" خمسة فصول.
في الفصل الأول، "مدخل منهجي"، يؤكد زيادة أن الدراسات التي اعتمدت سجلات المحاكم الشرعية ما زالت محدودة العدد والنتائج، "والواقع أن وضع هذه السجلات راهنًا - في طرابلس - لا يسمح بالاستفادة المرجوّة، وما دامت غير مصنّفة وغير مرقمة ترقيمًا علميًا، وما دامت فترات الانقطاع والثُّغَر والفجوات غير محصاة إحصاء دقيقًا، فإن عمل الباحث في الوقت الحالي سيكون انتقائيًا وعشوائيًا". وفي أحوال طرابلس في أيام العثمانيين، يقول زيادة إنها "احتفظت بتقاليدها المدينية، لكنها تحولت من عاصمة دولة - ولاية، إلى عاصمة إقليمية، واحتفظت بتأثيرها في حدود اللواء الذي ضم أقضية عدة في الترتيبات الإدارية اللاحقة". وإذ يحاول زيادة العثور على انعكاس لهذا التطور في الوثائق الطرابلسية، يقول إن "السجلات تمثّل، بالدرجة الأولى، نصًا مدينيًا، ويمكنها أن تساعد في إعادة تكوين صورة للمدينة لا تقتصر على جوانبها العمرانية، بل تشمل أيضًا علاقات الإنتاج والسلطة والرقابة السياسية والأيديولوجية". في الفصل الثاني، "الكتاب الشرعي والخطاب المرعي"، يتناول زيادة مسائل النص وحدوده وسلطة الخطاب، معالجًا ذلك من جوانب عدة، منها اللغوي إذ يقول: "يمكننا، من خلال التمييز اللغوي، أن نميز في الخطاب نوعين من السلطة: السلطة التي يتولاها القاضي، والسلطة التي يتولاها الوالي؛ ففي الواقع، كان القاضي يمثّل سلطة مستقلة بشكل تام عن سلطة الوالي، قبل الفصل الذي أقامته القوانين الحديثة بين السلطات"؛ ومنها السلطوي مستنتجًا: "إذا اعتبرنا السجلات مصدرًا للمعلومات، فإنها لن تقدم لنا إلا مزيدًا من المعطيات التي نضعها فوق ما لدينا من المعلومات التي نملك. لكن، إذا اعتبرنا هذه النصوص خطابًا يصدر عن سلطة ويملك سلطته ويكشف عن العلاقات التي تؤسس بنية لا تنطبق عليها بالضرورة بنية اجتماعية أخرى، وجب أن نستمع إلى فحوى هذا الخطاب لا أن نؤوِّله بحسب أغراضنا".
ديني ومدني
في الفصل الثالث، "الدستور المعظَّم: حاكم السياسة"، يقول زيادة إن سلطة الوالي كانت تحدّها سلطة القاضي، وهو من كان يشرف على الجهاز الإداري والشؤون المالية والعسكرية. وكان هذا الجهاز يتكون من غير الأهالي، وإن دخل بعض السكان المحليين في خدمة الوالي.
يركّز المؤلف في الفصل الرابع، "الحاكم الشرعي"، على تفصيل سلطة القاضي من خلال الوثائق الشرعية التي تقدّم فكرة واضحة عن دور هذا القاضي في الرقابة اليومية لحياة المدينة وإشرافه المباشر عليها، "ومع ذلك، ينبغي ألا نحصر دور القاضي في هذه القضايا، إذ إن رقابته كانت تشمل شؤون الجماعات أيضًا، وتنظيم علاقات بعضها ببعض". كان يستعين بالمطران للبحث في شؤون طائفته، وبالمفتي على سبيل الاستشارة، وينصّب مشايخ الحِرَف بطلب من أبناء كل حرفة. يكتب زيادة: "إن سلطة الحاكم الشرعي على جهاز العلماء واضحة ومباشرة إلى حد بعيد. وعلى الرغم من أن هذا الجهاز يتشكل بأغلبيته من الأهلين، فإن تعيينهم في وظائفهم أو خلعهم يجري بإشراف مباشر من الحاكم الشرعي، ما عدا المفتي أو من ينوب عنه موقتًا".
في الفصل الخامس، "المدينة المحمية"، يرسم زيادة فسيفساء المدينة اجتماعيًا في العهد العثماني. يكتب: "استطاع العبد أن يبدل وضعه الدوني إذا حظي بتحريره. أما المرأة، فلم تكن تملك تبديلًا لوضع هو معطى طبيعي، انعكس بحدة على وضعها القانوني والاجتماعي. ومال الفقهاء إلى مسايرة الموقف الاجتماعي السائد من المرأة وضرورة احتجابها واعتزالها في منزلها. إلا أن الحاكم الشرعي كان يضمن للمرأة حقوقًا مقرّرة شرعيًا". ويتضح لزيادة من خلال السجلات أن بعض المسيحيين عمل في التجارة والحِرَف والزراعة والصناعة، وأن علاقات وجهائهم بالولاة كانت قوية في الأمور التجارية والمالية. إلى ذلك، تقدم الوثائق هذه صورة واضحة لهيكلية الطوائف المهنية في طرابلس في تلك الحقبة.
أكثر من مجرد مصدر يتألف القسم الثاني، "دراسات في الوثائق الشرعية"، من ستة فصول. في الفصل السادس، "سجلات المحاكم الشرعية واقعها ودورها في البحث التاريخي – الاجتماعي"، يرى زيادة أن الاهتمام بالسجلات الشرعية في لبنان برز في بداية ثمانينيات القرن العشرين، من خلال الإصدارات والمؤتمرات. ومع ذلك، لم تكن السجلات الشرعية مجهولة، بل لفت الانتباه إليها المؤرخ أسد رستم منذ عام 1929 باعتبارها مصدرًا تاريخيًا. ويسرد زيادة وقائع أنشطة كان هدفها الاعتناء بالسجلات الشرعية، ثم يعرض أحوال السجلات في محاكم صور وصيدا وبيروت وطرابلس الشرعية، فيجد أن أول سجلات محكمة طرابلس يرجع إلى عام 1666، وهي الأقدم بين المحاكم الشرعية في لبنان. فطرابلس كانت عاصمة ولاية واسعة، ما يجعل من سجلاتها مصدرًا غنيًا للأقضية المحيطة بطرابلس، "ويصل عدد السجلات حتى نهاية الحقبة العثمانية إلى أكثر من مئة سجل". وفي تطور البحث التاريخي، تجاوزت هذه السجلات أن تكون مجرد مصدر، إذ فرضت طرائق جديدة للعمل، وأنتجت موضوعاتها الخاصة.
في الفصل السابع، "دور الوثائق في الحفاظ على التراث الحضاري المعماري"، يؤكد زيادة أن هذه الوثائق تساعد الباحثين عن التراث المعماري في إعادة تركيب صورة واقعية لحالة العمران في مرحلة محددة من الزمن، وتسمح لهم بتقدير حالة العمران...
- Format:
- Pages:336 pages
- Publication:2017
- Publisher:المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
- Edition:الطبعة الأولى
- Language:ara
- ISBN10:
- ISBN13:
- kindle Asin:B0FSKJT9FF